
تتم مراجعة جميع محتويات iLive طبياً أو التحقق من حقيقة الأمر لضمان أكبر قدر ممكن من الدقة الواقعية.
لدينا إرشادات صارمة من مصادرنا ونربط فقط بمواقع الوسائط ذات السمعة الطيبة ، ومؤسسات البحوث الأكاديمية ، وطبياً ، كلما أمكن ذلك استعراض الأقران الدراسات. لاحظ أن الأرقام الموجودة بين قوسين ([1] و [2] وما إلى ذلك) هي روابط قابلة للنقر على هذه الدراسات.
إذا كنت تشعر أن أيًا من المحتوى لدينا غير دقيق أو قديم. خلاف ذلك مشكوك فيه ، يرجى تحديده واضغط على Ctrl + Enter.
المثابرة
خبير طبي في المقال
آخر مراجعة: 04.07.2025
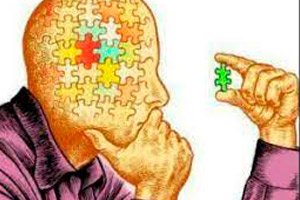
يتألف التكرار الذهني من تكرارات متكررة لأفعال وعبارات متطابقة، إلخ. يُظهر هذا التكرار نوعًا من "الجذب" في وعي أفكار أو أجزاء نشطة معينة تستمر في الوجود بعد الوقت الحاضر، ولا تعتمد على اتجاه النشاط، بل تُواصل نشاطها في الوعي البشري. غالبًا ما يُلاحظ التكرار المرضي لدى مرضى تلف الدماغ العضوي، وتصلب الشرايين الدماغية، والفصام، والخرف الشيخوخي، ومرض الزهايمر، ومرض بيك. [ 1 ]، [ 2 ]
ومع ذلك، فإن هذه المشكلة نموذجية ليس فقط في مجال الطب النفسي، بل أيضًا في مجالات طبية أخرى - وخاصة علاج النطق وعلم النفس العصبي.
علم الأوبئة
لا توجد إحصاءات خاصة حول معدل حدوث هذه الاضطرابات. يُفترض أن معدل حدوثها يتراوح بين ١١ و٦٥ حالة لكل مئة ألف نسمة.
تُلاحظ هذه الاضطرابات غالبًا في مرحلة الطفولة والشيخوخة، وهي أكثر شيوعًا لدى النساء منها لدى الرجال. ويزداد خطر الإصابة بها بعد سن الخمسين، ويبلغ معدل الإصابة ذروته في سن الشيخوخة والشيخوخة المبكرة (بعد سن الخامسة والستين).
الغالبية العظمى من حالات الاعتلال الدماغي الوعائي مجهولة السبب (لا يزال السبب غير واضح). في 10-30% فقط من الحالات، يمكن اكتشاف العوامل المؤهبة لتطور المرض: إصابات الدماغ الرضية، والعصاب، والخرف، وغيرها.
الأسباب المثابرة
السبب الرئيسي للاستمرارية هو فقدان القدرة على "التنقل" بين العمليات أو الأفعال الفردية في الدماغ، وفقًا لمبدأ الأولوية. قد يرتبط هذا الاضطراب بفشل وظيفي في نشاط الدماغ - على سبيل المثال، بسبب موقف مرهق، أو إرهاق، أو تطور الجهاز العصبي، أو أمراض عصابية. تُلاحظ اضطرابات مستمرة وشديدة على خلفية تلف دماغي عضوي، خاصةً إذا تضررت البنى تحت القشرية، والمناطق القشرية الثالثية، والقشرة الحركية الأمامية، والقشرة الجبهية الأمامية. بشكل عام، يمكن تقسيم الأسباب إلى ثلاث فئات من العوامل، بما في ذلك العوامل الفسيولوجية، والعوامل النفسية المرضية، والعوامل العصبية. [ 3 ]
يتعرض الكثير من الناس، تبعًا لمرحلة عمرية معينة، لظاهرة الإرهاق. قد يظهر هذا الاضطراب بضعف في وظيفة التحكم، في غياب مخطط واضح للنشاط، والذي قد ينتج عن الإرهاق العاطفي والجسدي، والإجهاد المطول، والإرهاق العام، و"الإرهاق النفسي". تتميز هذه الإرهاقات بتقلبات في الأداء، ومسارها خفيف. وتُعبر عنها بشكل رئيسي اضطرابات نفسية، ومظاهر عاطفية، وفي حالات نادرة جدًا - تغيرات في المهارات الحركية. [ 4 ]
الأسباب الأكثر شيوعًا لهذا الاضطراب هي الآفات العضوية الواضحة في الدماغ. وبالتالي، تظهر اضطرابات الحركة مع وجود اضطراب في الأجزاء الأمامية من نصفي الكرة المخية. إذا أثرت المشكلة على المناطق الحركية الأمامية والهياكل تحت القشرية الكامنة، يتطور اضطراب حركي أولي، مصحوبًا بأفعال مبرمجة متكررة متعددة. مع تلف المناطق السفلية من المناطق الحركية الأمامية في قشرة نصف الكرة المخية الأيسر، يُلاحظ اضطراب الكلام.
تنشأ اضطرابات النشاط العقلي على خلفية تلف الفصوص الجبهية من القشرة المخية: يصاحب هذا المرض تدهور في التحكم بالوظائف الفكرية، وتخطيط خاطئ للأفعال. تحدث تغيرات حساسة نتيجة تلف عضوي في مناطق التحليل القشري - أي مناطق معالجة المعلومات الواردة من أعضاء الحس. [ 5 ]
يعتبر الأطباء النفسيون المثابرة علامة على ضعف التكيف مع الأفعال العقلية أو النشاط العاطفي الإرادي. يُعد هذا الاضطراب شائعًا لدى الأشخاص ذوي سمات الشخصية الخاملة - على سبيل المثال، غالبًا ما يُلاحظ المثابرة لدى الأشخاص المصابين بمتلازمة الطالب المتفوق.
تجدر الإشارة أيضًا إلى أن النوبات المتواصلة قد تُلاحظ أيضًا في حالات التعب الشديد، وقلة النوم لفترات طويلة، وفي حالات التسمم. في مثل هذه الحالات، تكون الاضطرابات دائمًا عرضية، عابرة، وقصيرة الأمد. [ 6 ]
عوامل الخطر
العوامل التي يمكن أن تؤثر على تطور المثابرة قد تكون على النحو التالي:
- عمليات خاملة في الجهاز العصبي. يعاني بعض المرضى من تثبيط عمليات التبديل في الدماغ، وهو ما يُفسر بخصائص فسيولوجية. يجد هؤلاء الأشخاص صعوبة في الانتقال من مهمة إلى أخرى، ويتكيفون ببطء مع الظروف، ويميلون إلى تطوير أشكال خفيفة من المثابرة - على سبيل المثال، تبدو أفكارهم "عالقة" في عملية التواصل.
- التعب المفرط. إذا كان الشخص مُرهقًا جسديًا أو نفسيًا، فإنه يُعاني من اضطراب في عمليات التثبيط والإثارة في الدماغ، ويتأخر إتمام أي فعل. ولهذا السبب، في ظل التعب الشديد، يكون الحفاظ على رتابة الأفعال أسهل بكثير من الانتقال إلى مهام أخرى.
- الجهاز العصبي غير ناضج. في مرحلة الطفولة، وبسبب الخصائص الفسيولوجية، تسيطر عملية الإثارة وتبقى نشطة حتى بعد توقف تأثير المُهيج. قد يصاحب رد فعل الطفل ظهور حركات أو تعجبات متكررة.
- عمليات تصلب الشرايين. في تصلب الشرايين الدماغية، تترسب لويحات الكوليسترول في الأوعية الدموية، مما يُضيّق تجويف الشرايين، ويُعطّل الدورة الدموية، ويمنع تغذية خلايا الدماغ. في هذه الحالة، غالبًا ما تتجلى هذه الاضطرابات في اضطرابات الكلام.
- الخرف الشيخوخي، ومرض باركنسون، وأنواع الخرف الأخرى. الأمراض المصحوبة بعمليات ضمورية تحدث في قشرة الدماغ في منطقتي الفص الجبهي الصدغي والجبهي والهياكل تحت القشرية، تؤدي إلى اضطرابات فكرية حادة، وصعوبات في الكلام، وخلل في الممارسة. [ 7 ]
- إصابات الرأس، إصابات الدماغ الرضحية (TBI). تُلاحظ حالات تكرار الكلام بعد إصابات الدماغ، خاصةً مع تلف المناطق الحجاجية الجبهية الجانبية، والقشرة الجبهية الأمامية. يُعاني المريض من تكرار لا إرادي لعبارات أو كلمات فردية، ولكن التكرارات الفعالة غالبًا ما تكون على شكل عواقب بعيدة المدى.
- اضطرابات الدورة الدموية الدماغية. غالبًا ما تؤدي السكتة الدماغية إلى اضطرابات عصبية مختلفة: يفقد المرضى حساسيتهم ومهاراتهم الحركية النشطة، ويضعف الكلام والتنفس، ويصبح البلع صعبًا. قد تحدث مشاكل في اختيار الكلام، وفقدان السيطرة على ما يُقال.
- عمليات الأورام في الدماغ. في أورام الدماغ التي تصيب الفصوص الجبهية، والأجزاء القاعدية، والعقد الحركية تحت القشرية، غالبًا ما تُلاحظ تغيرات في سلوك الهدف، وفهم الأفعال، والانتقائية النشطة. كما تُلاحظ أيضًا ثباتات حركية أو حركية كلامية.
- التوحد. يُظهر مرضى التوحد تغيرات في الوظائف الحسية، وتثبيطًا للتفاعلات الحركية والعقلية، ونمطية سلوكية. تتجلى هذه التكرارات لدى المرضى بعبارات وأفعال متكررة خالية من المعنى، بالإضافة إلى اضطراب سلوكي وسواسي مستهدف.
- العصاب الوسواسي القهري. تتجلى اضطرابات الوسواس القهري في أفكار وأفعال وسواسية. تُلاحظ أفعال حركية لا إرادية متكررة، مصحوبة بأفكار وصور وسواسية.
- الفصام والتخلف العقلي. عندما لا تعمل عمليات إعادة التوجيه والإثارة بشكل صحيح، يصبح المرضى خاملين، ويصعب تكوين رابط منعكس شرطي. يعاني مرضى الفصام من توحيد أيديولوجي، ومحاولات لملء الفراغات بأفكار قديمة، وأتمتة الكلام والنشاط العقلي. وعلى وجه الخصوص، يُلاحظ، في سياق التصلب، تكرار الكلمات والعبارات وعدم ترابط الكلام.
طريقة تطور المرض
يُعدّ الأصل العصبي الأكثر شيوعًا بين اضطرابات المثابرة. يتميز هذا النوع بمجموعة واسعة من السلوكيات البشرية غير النمطية، والتي ترتبط بتلف نصفي الكرة المخية. وهذا ما يُسبب اختلال وظيفة الانتقال من فعل إلى آخر، وتغيرًا في اتجاه الأفكار وتسلسل الأفعال: إذ يحتل العنصر المثابرة مستوىً مهيمنًا على النشاط العقلي والوضع الموضوعي.
غالبًا ما تكون الاضطرابات النفسية العصبية نتيجة لإصابة دماغية رضية، وفقدان القدرة على الكلام (بعد الأورام والعمليات الالتهابية والإصابات)، والأمراض المحلية السابقة مع تلف الفصوص الأمامية من القشرة المخية.
المواظبة في علم النفس والطب النفسي سمة نفسية مرضية تتمثل في التكرار الدوري للأفعال الحركية، والارتباطات المستمرة، وتكرار الكلام. تعكس هذه الحالة المرضية عواقب الحالات النفسية المختلة، وغالبًا ما تكون سمة إضافية ومكونًا للمتلازمات المعقدة والاضطرابات الرهابية. [ 8 ]
إن ظهور هذه الأعراض لدى مريض لم يعاني من إصابة دماغية رضية سابقة أو ضغوط نفسية عميقة قد يشير إلى وجود مشاكل نفسية وعقلية.
العوامل المسببة للأمراض الأساسية لتطور هذا الاضطراب هي في أغلب الأحيان ما يلي:
- الانتقائية النموذجية والهوس بالاهتمامات، والتي غالبًا ما توجد لدى المرضى الذين لديهم ميل للإصابة بالتوحد؛
- الشعور بنقص الانتباه المصحوب بالنشاط المفرط، والذي يحفز ظهور المثابرة كنوع من رد الفعل الدفاعي الذي يهدف إلى جذب الانتباه إلى الذات؛
- الرغبة المستمرة والمفرطة في التعلم، ووجود قدرات إضافية يمكن أن يؤدي إلى أن يصبح الشخص مهووسًا ببعض الأنشطة؛
- قد تتواجد سمات اضطراب الوسواس القهري جنبًا إلى جنب مع الاضطرابات المثابرة.
إذا كان الشخص مهووسًا بفكرة ما، فقد تدفعه هذه الفكرة إلى القيام ببعض الأفعال دون وعي تام. ومن الأمثلة البارزة على ذلك اضطرابات الوسواس القهري، وخاصةً غسل اليدين الوسواسي، وتناول الأدوية باستمرار بدعوى الوقاية، وما إلى ذلك. في هذه الحالة، من المهم جدًا التمييز بين الوسواس القهري والأمراض الأخرى، بغض النظر عن سبب المرض. [ 9 ]
الأسباب الفسيولوجية للمشكلة:
- اضطراب وظيفي في القشرة المخية في منطقة الفص الجبهي؛
- إصابات الرأس في منطقة محدبة الفص الجبهي؛
- فقدان القدرة على الكلام بشكل متزايد.
العوامل النفسية لظهور المشكلة:
- الإجهاد لفترات طويلة؛
- الحالات الرهابية؛
- توحد؛
- فرط النشاط الحاد.
غالبًا ما تحدث هذه النوبات لدى المتخصصين العلميين الذين يدرسون نفس الموضوع لفترة طويلة. في الحالات الشديدة، قد يتفاقم الاضطراب إلى درجة الإصابة باضطراب الوسواس القهري، مثل السعي القهري وراء فكرة واحدة.
الأعراض المثابرة
إذا كانت النوبات ناجمة عن مرض ما، فسيظهر على المريض الأعراض المقابلة له. سنتناول بعد ذلك العلامات النموذجية لبعض الأمراض المصاحبة للنوبات.
في حالة النزيف الدماغي أو السكتة الدماغية، قد يعاني الشخص من الدوار والضعف واضطراب الكلام وفقدان حساسية العضلات. كما يضعف التنسيق الحركي وتتدهور الرؤية.
يمكن أن تسبب الأمراض العصبية تقلبات في المزاج وفقدان التوجه والصداع.
إن مصدرًا خطيرًا للاضطرابات مثل عملية الورم في الدماغ يتميز بالزيادة التدريجية في الدوخة الانتيابية، والصداع الشديد، وتطور العمى أو الصمم في جانب واحد، والإرهاق العام للجسم.
يمكن أن تتميز إصابات الدماغ الرضحية بالضعف العام والغثيان والصداع وضعف البصر والسمع واضطرابات الدهليزي.
يتميز التوحد بنقص التواصل العاطفي (بما في ذلك مع الوالدين)، وصعوبات في التنشئة الاجتماعية، وضعف الاهتمام بالألعاب. كما يُحتمل ظهور نوبات هستيرية وعدوانية.
في حالة الإصابة بالفصام، يعاني المرضى من حالات الوهم والهلوسة.
يتميز اضطراب الوسواس القهري بأفكار وسواسية، ورهاب، وسلوكيات قهرية. تتمثل أولى علامات الاضطراب فيما يلي: فقدان الشخص ثقته بنفسه، والشك الدائم في أفعاله. يعاني العديد من المرضى من نقص في الكمال: يميل هؤلاء الأشخاص إلى نشر الغسيل حسب اللون وعلى نفس المستوى، ووضع الأواني بحيث تكون مقابضها متجهة نحو جهة معينة، وترتيب الجوارب حسب اللون، وما إلى ذلك. في الوقت نفسه، لا نتحدث عن الرغبة المعتادة في النظام: يشعر المريض بانزعاج "مفرط" من "الاضطراب" الوهمي، وقد يحاول إصلاح "الاضطراب" حتى عند زيارته.
المثابرة عند الطفل
غالبًا ما تظهر المثابرة في مرحلة الطفولة، ويعود ذلك إلى خصائص نفسية ووظائف أعضاء الأطفال، بالإضافة إلى التغيرات النشطة في أولويات الحياة خلال مراحل النمو المختلفة. يصعب أحيانًا على المتخصصين التمييز بين علامات المثابرة الحقيقية والعلامات المتعمدة، وكذلك بين تلك التي تشير إلى وجود أمراض نفسية أكثر تعقيدًا. [ 10 ]
يلعب الآباء دورًا رئيسيًا في تحديد الأمراض عند الأطفال: يُنصح بمراقبة الطفل بعناية وتسجيل أي مظاهر للمثابرة - على سبيل المثال، مثل:
- التكرار الدوري للعبارات المتطابقة، بغض النظر عن الظروف والأسئلة المطروحة، فضلاً عن المثابرة على الكلمات؛
- التكرارات المنتظمة للأفعال الفردية - على سبيل المثال، لمس مكان معين في الجسم، والنقر، وما إلى ذلك؛
- إعادة إنتاج الأشياء المتطابقة (الصور، العبارات، الأسئلة، وما إلى ذلك)؛
- تكرار الطلبات التي لا تناسب مواقف معينة.
من المهم التمييز بين الاضطرابات المرضية وأنشطة اللعب وعادات الطفولة الطبيعية. من الضروري التحدث مع الطفل بهدوء ودون إزعاج، واستشارة متخصصين عند الضرورة. [ 11 ]
إستمارات
اعتمادًا على مظاهر الاضطراب، يميز الأطباء بين أنواع الاضطرابات الحركية والعقلية (الفكرية). [ 12 ]
التكرار الحركي هو تكرار مستمر لنفس الحركة أو سلسلة كاملة من الحركات المتكررة. لهذه الأفعال خوارزمية معينة تبقى ثابتة لفترة طويلة. على سبيل المثال، في محاولات يائسة لتشغيل التلفزيون، يبدأ الشخص بالضرب عليه بقبضته. لا يؤدي هذا الفعل إلى أي شيء، ولكن، بعد إدراكه لذلك، يكرره مرارًا وتكرارًا. قد يظهر مظهر آخر لدى الأطفال: يبحث الطفل عمدًا عن لعبة حيث لا توجد.
تظهر المثابرة الفكرية على شكل جمود غير طبيعي في الأفكار والتصريحات والاستنتاجات. تتجلى في التكرار المستمر للكلمات أو العبارات. يسهل نسبيًا اكتشاف هذا الاضطراب: يطرح الطبيب سلسلة من الأسئلة، ويجيب المريض عليها جميعًا باستخدام أول إجابة. هناك أيضًا أشكال خفيفة من الاضطراب، حيث يحاول المريض بانتظام مناقشة قضية مطولة أو موضوع نقاش.
المثابرة الحركية
تنقسم أنواع المثاقب الحركية حسب المبدأ التالي:
- تتكون المثابرة الأولية من تكرار فعل واحد؛
- تتضمن المثابرة النظامية قيام الشخص بتكرار مجموعة كاملة من الإجراءات.
يتم إعطاء فئة منفصلة لاضطراب الاستمرار في الكلام، والذي يتجلى في إعادة إنتاج نفس الكلمة (العبارة)، سواء شفهيًا أو كتابيًا.
بشكل عام، تحدث التشنجات الحركية، أو التشنجات الحركية، نتيجة تلف في المناطق الحركية في الدماغ. يعاني المرضى من تكرارات متعددة لعناصر أي حركة أو فعل.
المثابرة في التفكير
يتميز هذا النوع من الاضطراب بتشويش فكرة أو فكرة معينة في الوعي البشري، وغالبًا ما يتجلى ذلك في عملية التواصل اللفظي. يستطيع المريض الرد على أي طلب أو سؤال تقريبًا، حتى لو لم يكن مرتبطًا، بنفس الكلمة أو العبارة. من الممكن نطق كلمات معينة بصوت عالٍ دون توجيه (كأنه يتحدث إلى نفسه). من السمات المميزة للاضطرابات العقلية: محاولة الشخص باستمرار العودة إلى موضوع محادثة انغلق منذ فترة طويلة، والتحدث عن قضايا لم تعد ذات صلة. الاسم الثاني للاضطرابات العقلية هو "العقلية".
التكرارات والتكرارات
فقدان القدرة على الكلام (بارافاسيا) هو اضطراب في الكلام، حيث تُستبدل الكلمات أو الحروف الصحيحة بأخرى غير مناسبة وغير مفهومة في لحظة معينة. يتحدث الشخص المصاب بهذا الاضطراب بشكل غير طبيعي، ويكون كلامه غير صحيح، وغالبًا ما يحتوي على كلمات غير موجودة. بالإضافة إلى ذلك، قد يتشوه الكلام، بل قد يتسارع أو يبطئ، مما يُصعّب على الآخرين فهمه. غالبًا ما يصاحب هذا الاضطراب دمج الكلمات، واستخدامها وخلطها بشكل غير صحيح، والتكرار. الأسباب الرئيسية لهذا المرض هي إصابات الرأس، والسكتات الدماغية، والالتهابات الشديدة المصاحبة لمضاعفات دماغية، والانصمام الخثاري، والأورام والعمليات الكيسية في الدماغ، وفتح تمدد الأوعية الدموية. تعتمد استراتيجية علاج هذا المرض على كل حالة على حدة.
المثابرة في فقدان القدرة على الكلام
التكرار هو أيضًا سمة مميزة لفقدان الذاكرة. يُسمي المريض أول شيء يُعرض عليه، ثم يُسمي جميع الأشياء الأخرى بنفس المصطلحات. على سبيل المثال، عند رؤية إبريق شاي، قد يقول المريض: "هذا للماء، لغليه، لتشربه لاحقًا". بعد ذلك، يُعرض عليه مقص، فيقول: "هذا إبريق شاي للتقطيع، كان لديّ واحد مثله".
ومن الجدير بالذكر أن المرضى أنفسهم لا يلاحظون أي خلل إذا تأثر محلل إدراك الكلام في نفس الوقت، وهو ما يحدث في حالة فقدان القدرة على الكلام الحسي الحركي.
في متلازمة فقدان القدرة على الكلام، تُعتبر هذه الاضطرابات عنصرًا هيكليًا، ولذلك تستمر طويلًا، حتى مع اختفاء علامات فقدان القدرة على الكلام الأساسية. كما تُلاحظ الاضطرابات على خلفية أمراض دماغية عضوية غير مركزية، مثل تصلب الشرايين الدماغية وقلة القدرة على الكلام.
ثبات الحروف أو الكلمات
المثابرة في الكتابة أو الكلام هي إعادة إنتاج حرف أو مقطع لفظي كُتب أو نُطق للتو بدلاً من الحرف أو المقطع الضروري التالي. مثال: занок - بدلاً من заука؛ жожотные - بدلاً من животные. [ 13 ]
يمكن أن يظهر تشويه محدد في التركيب الصوتي للكلمات في كل من الكلام الشفهي والمكتوب، وله طابع الاستيعاب التقدمي والتراجعي.
يعد إتقان المقاطع أو الحروف أحد أشكال اضطرابات الإتقان الحركي، لأنه يتكون من إعادة إنتاج النشاط البدني - على سبيل المثال، كتابة الكلمات. [ 14 ]
لكن المثابرة في علاج النطق هي تشويش مستمر في الحروف، مما يُضعف جودة الكلام بشكل عام. يعاني الطفل من نوع من "التلعثم" في الحروف - غالبًا ما تكون حروفًا ساكنة، كما لو كانت تُستبدل في كلمة. أمثلة على أعراض المثابرة في علاج النطق:
- في كلمة أو عبارة واحدة: "dodoga" بدلاً من "road"، "pod postom" بدلاً من "pod mostom"، إلخ؛
- على خلفية ضعف التثبيط التفاضلي: "لقد لعبنا"، "حكينا القصص"، "سنصبح أغنياء"، أناس أثرياء.
من الممكن أن يتم تسجيل التلوثات في نفس الوقت - خلط المقاطع وأجزاء الكلمات - على سبيل المثال، "dogazin" هو مزيج من house + store.
مثل التلوث، فإن المثابرة هي اضطراب شائع في بنية المقطع في مرحلة الطفولة. [ 15 ]
المثابرة والتكرار
مصطلح "المثابرة" مشتق من الكلمة اللاتينية "perseverа tio"، والتي تعني المثابرة. في عملية الكلام، تتجلى هذه الأعراض في تكرار نفس الأصوات والكلمات والعبارات.
يتباطأ وعي المريض عند كلمة أو فكرة واحدة، مما يؤدي إلى تكرارها بشكل متكرر ورتيب. عادةً، لا يرتبط هذا التكرار بموضوع المحادثة أو الموقف. قد يظهر هذا الاضطراب أيضًا في شكل كتابي، كونه نتيجةً لارتباط النشاط. لا يمكن مقارنته بالظواهر الوسواسية، إذ تتضمن الأخيرة عنصرًا من الوسواس، ويدرك الشخص نفسه بوعي خطأ أفعاله. [ 16 ]
إلى جانب المثابرة، غالبًا ما يُلاحظ التكرار في الفصام. نتحدث هنا عن اضطرابات نفسية يكرر فيها المريض نفس المقاطع والكلمات والعبارات بصوت عالٍ ورتيب. لكن هذا التكرار يكون تلقائيًّا، ويفتقر إلى المضمون، وقد يستمر لساعات أو حتى أيام.
ينطق المريض تركيبات صوتية أو كلمات فارغة تمامًا من المعنى، بإيقاع معين، وأحيانًا بقافية. من المهم التمييز بين التكرارات المتكررة والتكرارات المثابرة، إذ ترتبط نوبات التكرار في هذه الأخيرة بالحالة النفسية العصبية للشخص، وتزول مع تطبيع هذه الحالة.
تتميز هذه الصيغ بتكرار الشخص لكلمات تعجب وأصوات دون أي تأثر. وعادةً ما يكون النطق مصحوبًا بتعبيرات وجه نشطة واضطرابات حركية. وفي معظم الحالات، تحدث هذه المشكلة لدى مرضى الخرف والفصام الجامودي.
المثابرة والسلوك الظرفي
مع نمو الطفل، يواجه حتمًا حقيقةً تلعب دورًا هامًا في تطور تفكيره. بمراقبته للعالم من حوله، يلاحظ انتظام تسلسل الظواهر الفردية: على سبيل المثال، إذا أخرجت الأم حذاءً من الخزانة، فسيكون هناك نزهة، وإذا وضعت الأطباق على الطاولة، فستتبعها وجبة طعام. لا يدرك الأطفال فورًا هذه الصلة أو تلك بين الظواهر: في البداية، يؤكدون على سلسلة التسلسلات المعتادة. وقوع حدث ما يستلزم توقع الحدث التالي. لا يشير هذا التسلسل دائمًا إلى الترابط بين الظواهر، ولكنه يؤدي إلى الخبرة العملية للطفل، الذي يبدأ بملاحظة التغيرات التي تحدث في بيئته وبيئتها المحيطة.
من المهم أن نفهم أننا لا نتحدث عن التكرار التلقائي لنفس الأحداث بنفس التسلسل، بل عن التغييرات التي تحدث في بيئة الطفل نتيجة لأفعال معينة.
إذا تم انتهاك التسلسل المعتاد، فإن ذلك يجذب انتباه الطفل، ويسبب سوء فهم، ويخلق حاجة إلى تفسير. ما الذي يجب أن يشعر به الأطفال في مثل هذه الحالة؟ إنه شعور بالدهشة والفضول وعدم الفهم. إذا كان انتهاك التسلسل المعتاد يُشعر الطفل بألم (يُعيد كل شيء إلى مكانه باستمرار، رغم تفسيرات الكبار)، فيجب التفكير في وجود بعض مشاكل المثابرة.
المثابرة والصور النمطية
النمطية هي ميلٌ لتكرار نفس الأفعال. قد تشمل النمطية تكرار كلماتٍ مُحددة أو التفكير النمطي (التكرار).
تختلف العمليات النمطية أيضًا في درجة أتمتتها. على سبيل المثال، تتميز التعبيرات الشفوية - وهي مظاهر نمطية في الكلام العامي لمرضى الفصام - بتكرار لا واعي، آلي، لا معنى له، لكلمات أو عبارات متطابقة. وتُعتبر الصور النمطية الحركية أو الهلوسية آلية بنفس القدر. وغالبًا ما تظهر الهلوسة في ظل وعي غير واضح بما يكفي - كما هو الحال في حالات التسمم الحاد أو العدوى. أما الصور النمطية العقلية، فهي أكثر تعسفًا، ولكن في هذه الحالة، يعود الدور الرئيسي إلى حالات الأتمتة العقلية.
الصور النمطية ليست استمرارًا. ففيها، يُدرج فعلٌ مُنجزٌ كليًا أو جزئيًا في الفعل التالي، في مهمة جديدة، دون أي صلة بالسابقة. تتميز الصور النمطية بفقدان معنى النشاط (العقلي، الحركي، الكلامي)، دون أي صلة بحل أي مهمة. تُفقد القدرة على فهم العلاقة بين أنماط العبارات النمطية (العقلية أو الكلامية).
الصور النمطية طويلة الأمد، ولا تتغير بتأثير تغيير النشاط. تعتمد المثابرة على درجة تعقيد المهمة اللاحقة، فهي أسهل في الظهور، وتتشابه مع النشاط السابق. على عكس الصور النمطية، يحاول المريض مقاومة المثابرة.
لا تقتصر الصور النمطية على الفصام فحسب، بل تُشخَّص أيضًا في حالات الذهان العضوي.
المثابرة والتوقعات
تُعتبر بعض اضطرابات الكلام اضطرابات صوتية، أو اضطرابات تتعلق بالبنية الصوتية للغة. وأكثر هذه الاضطرابات شيوعًا هي التكرار والتوقع.
مع المثابرة، تنتهي الأصوات من الكلمة الأولى في الكلمات اللاحقة - على سبيل المثال، "snezhny suzhnob" بدلاً من "snezhny suguro"، "bolit bolova" بدلاً من "bolit golova".
إذا تحدثنا عن التوقع، فإننا نتحدث عن عمليات معاكسة للمثابرة. على سبيل المثال، يُخطئ شخص ما في تسمية صوت من كلمة لاحقة:
- تشرق الشمس على نفسها (بدلاً من "في السماء")؛
- سأشاهد مسلسلًا تلفزيونيًا (بدلاً من "مشاهدة مسلسل تلفزيوني").
في النسخة المثابرة، يمكن افتراض أن الشخص ببساطة ارتبك ونطق عن طريق الخطأ الصوت من الكلمة السابقة، على الرغم من أن هذا ليس هو الحال.
إيكوبراكسيا والمثابرة
إيكوبراكسيا، أو إيكوكينيزيا، أو إيكوكينيزيا، هي ما يُسمى بأعراض الصدى، وتتميز بتكرار أو تقليد لا إرادي لأي حركة أو إيماءة أو وضعية جسدية، إلخ. تتميز معظم حالات إيكوبراكسيا بتكرار حركات بسيطة نسبيًا تُؤدى أمام الشخص، مثل التصفيق أو التحديق أو التلويح باليدين. يصاحب تلف القشرة الجبهية الأمامية المحدبة أمام المناطق الحركية الأمامية فقدان القدرة على الحركة في الفص الجبهي مع أعراض إيكوبراكسيا.
تُعزى هذه الأعراض عادةً إلى اضطرابات التشنجات اللاإرادية. وتُلاحظ في التوحد، ومتلازمة توريت ، والفصام (وخاصةً النوع الجامد)، وقلة فينيل بيروفيك، وداء بيك ، والحالة الاكتئابية السريرية، وغيرها من الأمراض العصبية. قد يصاحب الفصام الجامد، بالإضافة إلى صدى الكلام ، تكرار كلام الآخرين، وتكرار تعابير الوجه. [ 17 ]
المثابرة السلوكية
يصف الخبراء التكرار بأنه اضطرابات سلوكية، ويمكن أن يتعلق التكرار بأي تصرفات أو عبارات أو حركات أو أسئلة أو طلبات، وما إلى ذلك. التكرار في السلوك هو مظهر من مظاهر خلل القشرة الحركية الأمامية، عندما يكون الانتقال من إجراء مكتمل بالفعل إلى الإجراء التالي صعبًا: ونتيجة لذلك، لا ينتقل الإجراء الأول إلى الإجراء التالي، بل يتكرر، مما لا يسمح بتحقيق الهدف الأصلي.
يُستخدم الميل إلى المثابرة في مراحل مختلفة من التنشئة الاجتماعية للأطفال الذين يعانون من اضطرابات حركية صادرة والتوحد - وهي أمراض ذات مستويات متفاوتة من خلل في القشرة الجبهية. يُساعد الاستخدام الكفؤ لهذا الميل على توطيد العلاقات بفعالية في مرحلة الطفولة. وبالتالي، قد لا تُمثل المثابرة السلوكية في بعض الحالات عائقًا مرضيًا، بل قد تُشكل أيضًا حليفًا في العمل الإصلاحي. [ 18 ]
ثباتات المحرك العيني
يُقال إن الثبات الحركي للعين يحدث عندما يُحدِّق الشخص بعينيه في شيءٍ ما. ليس من الممكن دائمًا الإجابة فورًا على السؤال حول الأصل المرضي لمثل هذه الأعراض، ولكن في كثير من المرضى، قد تسبق الاضطرابات العقلية والإدراكية الاضطرابات الحركية.
لتشخيص الحالة ينصح بما يلي:
- تقييم وجود ضعف إدراكي محتمل لدى الشخص؛
- تقييم وجود اضطرابات نفسية؛
- سيوضح المعلومات حول استقرار الجهاز العصبي، وغياب الأمراض العصبية والجهازية.
تُقيّم الإعاقات الإدراكية باستخدام اختبارات نفسية عصبية محددة. غالبًا ما تتجلى الاضطرابات النفسية في القلق و/أو الاكتئاب. بالإضافة إلى ذلك، قد يعاني المرضى من التهيج، وتقلب المزاج، واللامبالاة، والعدوانية، واضطرابات التفكير و/أو الحركة، واضطرابات الوسواس القهري، وفي حالات أقل شيوعًا، الذهان. يُحدد التشخيص النهائي بناءً على بيانات الاختبارات التشخيصية.
المثابرة في مرض الفصام
كثيرًا ما نلاحظ حالات ثبات الكلام لدى مرضى الفصام. تشمل هذه الاضطرابات طيفًا واسعًا من مظاهر الكلام. في هذه الحالة، قد يكون ثبات الكلام عبارة عن أصوات وكلمات فردية، أو أجزاء من عبارات، أو تقلبات كلامية كاملة. يربط العديد من المتخصصين حدوث ثبات الكلام لدى مرضى الفصام بضعف الأفكار والميل إلى ملء الفراغات الذهنية الناتجة بأفكار سابقة. أما من الناحية المرضية، فيلعب تعزيز أتمتة النشاط الفكري والكلامي دورًا هامًا.
عادةً ما تصاحب اضطرابات الفصام اضطرابات في التفكير والإدراك، وضعف أو انخفاض في المشاعر. في معظم الحالات، يحتفظ المرضى بوعيهم وقدراتهم العقلية صافية، مع احتمال ظهور بعض المشاكل الإدراكية مع مرور السنين.
في الفصام، تتعطل الوظائف الأساسية التي تمنح الأشخاص الطبيعيين إحساسًا بفرديتهم وهدفهم. غالبًا ما تُلاحظ هلاوس سمعية، وهذيان تفسيري، وإدراك للألوان أو الأصوات. يصبح التفكير غامضًا ومبهمًا ومتقطعًا، ويصبح الكلام غير مفهوم. من المحتمل حدوث اضطرابات جامودية. [ 19 ]
المضاعفات والنتائج
قد يرتبط ظهور مضاعفات الاعتلال العصبي بتطور المرض الأساسي أو بإضافة اضطرابات عقلية أو غيرها.
على سبيل المثال، إذا لم تُصحَّح حالات المثابرة أو لم تتحسن لفترة طويلة، فقد يُصاب المريض باضطرابات اكتئابية، واضطرابات قلق، وحتى أفكار انتحارية. ويعود ذلك إلى أسباب عديدة:
- عدم القدرة على التخلص من المثابرة بشكل مستقل؛
- الشعور بالنقص، وعدم الثقة بالنفس؛
- الإدانة من الأقارب والأصدقاء وما إلى ذلك.
بالإضافة إلى ذلك، كثيراً ما نتحدث عن حالات إساءة استخدام المهدئات والمسكنات والمؤثرات العقلية والمشروبات الكحولية، مما يؤثر سلباً على نتائج العلاج والحالة النفسية للمريض. في حالات الوسواس القهري الشديد، والأورام، والخرف، تتدهور جودة حياة المرضى بشكل ملحوظ. تتدهور الوظائف الاجتماعية الطبيعية، وتتراجع القدرة على العمل، وتضعف مهارات التواصل.
ولكن من المهم أن نلاحظ أنه في جميع الحالات من الضروري إجراء تشخيص تفريقي واضح وعميق مع مختلف الاضطرابات العقلية والأمراض الجهازية والتسمم وما إلى ذلك. من المستحيل استبعاد ظهور المثابرة بشكل عرضي فقط، دون أي دافع: في مثل هذه المواقف، غالبًا ما يشعر الناس بالخوف، ويواجهون صعوبة في تحقيق الذات، حيث يتعرضون لضغط نشط وسوء فهم ومعارضة من أحبائهم.
ومع التطور المفاجئ لمثل هذه الاضطرابات، من المرجح أن تظهر دوافع أخرى، بما في ذلك أفعال إيذاء النفس، والعدوان، وما إلى ذلك.
التشخيص المثابرة
قبل إجراء الإجراءات التشخيصية، يجري الطبيب محادثة مع المريض أو والديه أو أقاربه. [ 20 ] ويتم توضيح الأسئلة التالية:
- الحالات الوراثية من الأمراض، بما في ذلك الأمراض العقلية؛
- العمر الذي ظهرت فيه العلامات الأولى للاضطرابات؛
- جودة الوظيفة الاجتماعية؛
- الأعراض والأمراض المصاحبة والعوامل غير المواتية؛
- سمات سلوك المريض أثناء الفحص والمحادثة، والتوجه في المكان والزمان، وما إلى ذلك؛
- حالة جسدية وعصبية.
يتم تقييم الحالة النفسية والعصبية للمريض من خلال جمع المعلومات عنه وعن تاريخه المرضي، سواءً من الشخص نفسه أو من المقربين منه. تُجمع الشكاوى، وتُفحص الوظائف الحركية، وردود أفعال الوجه، والاضطرابات الحشوية الخضرية بصريًا. [ 21 ] ويُقيّم مستوى المثابرة والقلق وتوتر العضلات لدى المريض خارجيًا. كما يُتأكد من وجود تعب، وضعف، وتوتر، وتهيج، واضطرابات في النوم. ومن بين التغيرات الخضرية، يُولى الاهتمام لزيادة معدل ضربات القلب، ورعشة في الأصابع والأطراف، وزيادة التعرق، والغثيان، والتبول، واضطرابات الهضم. [ 22 ]
لإجراء فحص بدني، يُمكن استشارة معالج نفسي أو طبيب أطفال أو طبيب نفسي أو طبيب أعصاب. خلال الفحص العصبي، يُحدد ما يلي:
- اضطرابات الأعصاب القحفية؛
- وجود وتغير ردود الفعل، ووجود الحركات الإرادية؛
- اضطرابات خارج هرمية (نقص الحركة، فرط الحركة، الرمع العضلي)؛
- اضطرابات في التنسيق الحركي والحساسية؛
- اضطرابات وظيفية في الجهاز العصبي اللاإرادي.
تشمل التشخيصات الإضافية ما يلي:
- - فحوصات الدم السريرية والكيميائية الحيوية (بما في ذلك مستويات الجلوكوز، ALT، AST، الفوسفاتيز القلوي)، اختبار الثيمول.
- تفاعل واسرمان، اختبار الدم لفيروس نقص المناعة البشرية.
- تحليل البول السريري.
- تخطيط القلب الكهربائي.
- إذا لزم الأمر: تحليل بكتيري، مسحة من الأنف والحلق.
إذا كان من الضروري استبعاد الأمراض العضوية في الجهاز العصبي المركزي، يتم إجراء التشخيص الآلي:
- تخطيط كهربية الدماغ؛
- التصوير بالرنين المغناطيسي؛
- التصوير المقطعي المحوسب.
يساعد إجراء شائع، وهو تخطيط كهربية الدماغ، في الكشف عن الميول الصرعية وتقييم نضج الدماغ ونشاطه الوظيفي. [ 23 ]
تشخيص متباين
بغض النظر عن الأصل السببي للاستمرار، يجب تمييزه عن الأمراض والحالات التالية:
- اضطرابات الوسواس القهري ؛
- العادات البشرية المشتركة؛
- اضطرابات الذاكرة التصلبية.
من الشائع جدًا أن نرى أشخاصًا (خاصة كبار السن) يميلون إلى تكرار نفس العبارات أو الكلمات أو الأفعال لمجرد ضعف الذاكرة أو ضعف التركيز.
من المهم ملاحظة ظهور أعراض لدى المريض، مثل الأفكار الوسواسية والأفعال القهرية. إذ ينظر المرضى أنفسهم إلى هذه الهواجس على أنها أمر غريب وغير مفهوم من الناحية النفسية.
الأفكار الوسواسية هي أفكار مؤلمة، وتمثيلات تنشأ بغض النظر عن إرادة الشخص. تبدو هذه الصور أشبه بصور نمطية، ويحاول الشخص مقاومتها بنشاط. الصور الوسواسية المتقطعة غير مكتملة، مع مجموعة كاملة من البدائل: إنها ناتجة عن فقدان المريض قدرته على اتخاذ حتى أبسط قرار، كما هو الحال في شؤون الحياة اليومية العادية.
تتطلب الأفعال القهرية تشخيصات تفاضلية إلزامية - صور نمطية على شكل أفعال متكررة، وأحيانًا أفعال طقسية، تلعب دور نوع من الحماية ووسيلة لتخفيف التوتر القلق المفرط. ترتبط الغالبية العظمى من الأفعال القهرية بفحوصات متكررة - يُفترض أنها تهدف إلى ضمان استبعاد إضافي للحظة أو موقف خطير محتمل. غالبًا ما يكون أساس هذا الاضطراب هو رهاب الخطر - وهو توقع وهمي لبرنامج سلبي غير متوقع، سواءً للمريض نفسه أو لبيئته.
من الاتصال؟
علاج او معاملة المثابرة
أساس التخلص من الانحرافات الإدراكية هو اتباع نهج شامل ومتدرج. تجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد نظام علاجي قياسي ومُجرّب للانحرافات الإدراكية، إذ يُختار العلاج بشكل فردي. إذا شُخِّص المريض بأمراض عصبية في الدماغ، فيجب إدراج الأدوية في نظام العلاج. ومن المناسب تحديدًا استخدام المهدئات ذات التأثير المركزي، بالإضافة إلى الفيتامينات المتعددة والمنشطات الذهنية.
قد تشمل المساعدة النفسية النقاط الاستراتيجية الرئيسية التالية:
- تتمثل استراتيجية التوقع في مراقبة وانتظار تغيرات معينة نتيجةً لأي وصفات طبية (أدوية أو إجراءات). يتيح لنا هذا الإجراء تحديد مدى استمرار الأعراض المرضية.
- تتضمن الاستراتيجية الوقائية منع تحول الاضطرابات النفسية إلى اضطرابات حركية، أو تضافرها. وتعتمد هذه الطريقة عادةً على استبعاد النشاط البدني الأكثر إيلامًا للمريض.
- تتمثل استراتيجية إعادة التوجيه في تغيير اتجاه النشاط البدني أو العاطفي للشخص. مع تغيير حاد في موضوع الحديث، أو طبيعة النشاط، يُصرف انتباه المريض عن حالات الوسواس.
- تساعد الاستراتيجية المحدودة على تقليل درجة التعلق المُستمر من خلال الحد من تصرفات المريض. يُقلل النشاط الوسواسي إلى حد معين: على سبيل المثال، يُسمح ببعض الأفعال الاستفزازية فقط خلال فترة زمنية محددة بدقة.
- تهدف استراتيجية الاستبعاد المفاجئ إلى إيقاف المضايقات فورًا بوضع المريض في حالة صدمة. على سبيل المثال، يمكن توقع هذا التأثير من الصراخ العالي المفاجئ، أو من تصور ضرر مباشر ناجم عن أعراض مرضية.
- تتضمن استراتيجية التجاهل تجاهل المثابرة تمامًا. يُعد هذا الإجراء مثاليًا إذا كان العامل المُحفِّز هو نقص الانتباه. عندما لا يحصل المريض على التأثير المتوقع، يتلاشى معنى أفعاله.
- تتمثل استراتيجية التفاهم المتبادل في إيجاد نهج للتعامل مع المريض، وإقامة اتصال قائم على الثقة معه، مما يساعد الشخص على تنظيم أفكاره وأفعاله.
غالبًا ما تكون هناك حاجة إلى استخدام العلاج بمضادات الاكتئاب. على وجه الخصوص، في حالة اضطراب الوسواس القهري، يُوصف العلاج الأحادي بمضادات الاكتئاب في المرحلة العلاجية الأولية. إذا لم يُحقق هذا النهج التأثير المطلوب، يُوسّع نطاق العلاج بأدوية من مجموعات واتجاهات أخرى. في جميع الحالات، يجب أن يكون المريض تحت إشراف طبي دقيق. في الحالات المعقدة، يُدخل المريض إلى المستشفى، وفي حالة وجود مسار مرضي خفيف، يُفضّل العلاج في العيادات الخارجية.
يُعدّ العلاج النفسي إحدى الطرق الفعّالة. حتى الآن، ثَبُتَ التأثير الإيجابي للعلاج السلوكي المعرفي في مختلف المجالات، والذي يتبيّن أحيانًا أنه أكثر فعالية من تناول الأدوية. بالإضافة إلى ذلك، يُستخدم العلاج النفسي غالبًا لتعزيز تأثير الأدوية، وهو أمر بالغ الأهمية للمرضى الذين يعانون من اضطرابات حادة.
تُقبل خطط العلاج الفردية، والعمل الجماعي، والعلاج النفسي الأسري. في معظم الحالات، يجب أن يكون الإشراف الطبي طويل الأمد، لا يقل عن ١٢ شهرًا. حتى لو أمكن إيقاف الأعراض المرضية في غضون أسابيع قليلة، فإن إيقاف الإشراف الطبي غير مقبول.
تعتبر الأساليب غير الدوائية مناسبة مثل التدخلات النفسية الاجتماعية والعلاج السلوكي المعرفي.
الأدوية
يعتمد استخدام بعض الأدوية لعلاج التصلب المتعدد على مسار المرض أو الحالة المرضية الكامنة. لذا، تُوصف الأدوية لكل حالة على حدة، فلا توجد منهجية عامة للعلاج المحافظ.
في حالات التدهور الدماغي، تُستخدم مضادات الاكتئاب متوازنة المفعول ذات القدرة العالية على تحفيز إفراز الغدة الزعترية وخصائص مضادة للقلق. ينبغي اختيار الأدوية مع مراعاة آثارها الجانبية: يُفضل وصف أدوية ذات تأثير أقل انتصابًا (نورتريبتيلين، دوكسيبين) وتأثير مضاد للكولين (ترازودون، ديسيبرامين). [ 24 ]
في حالة الإصابة بمرض الزهايمر يتم إجراء الآتي:
- العلاج البديل للتعويض عن نقص الكولين في الأنظمة العصبية؛
- العلاج العصبي الوقائي لتعزيز بقاء الأعصاب والتكيف؛
- العلاج الوعائي والمضاد للالتهابات.
- يتم إجراء العلاج البديل باستخدام مثبطات الأسيتيل كولينستراز:
- إكسيلون (ريفاستيجمين) - يُؤخذ مرتين يوميًا، صباحًا ومساءً، بدءًا من ١.٥ ملغ. جرعة فعالة إضافية للمحافظة على مفعول الدواء - من ٣ إلى ٦ ملغ مرتين يوميًا. الآثار الجانبية المحتملة: ارتباك، هياج، دوخة، فقدان الشهية، زيادة التعرق.
- يُوصف أريسيبت (دونيبيزيل) للبالغين بجرعة ٥ ملغ يوميًا ليلًا. يُحدد الطبيب مدة العلاج. الآثار الجانبية المحتملة: إسهال، غثيان، هياج، صداع، زيادة التعب.
مع العلاج بهذه الأدوية، يتم التخلص من التورمات خلال الأسابيع الثلاثة إلى الأربعة الأولى من العلاج.
يلعب الجلياتيلين، وهو مشتق من الكولين، دورًا خاصًا في عمليات تعزيز النشاط الكوليني المركزي. أما أكاتينول ميمانتين، فهو معدِّل للجهاز الغلوتاماتي، وهو عنصر مهم في عمليات الذاكرة والتعلم. وقد لوحظ تأثير جيد من استخدام هذا الدواء في حالات الخرف الخفيفة والمتوسطة. بالإضافة إلى ذلك، يُحسّن الدواء الحالة العاطفية والوظائف الحركية للمرضى.
يهدف العلاج الوقائي للأعصاب إلى تحسين حيوية الخلايا العصبية. يُنصح باستخدام الأدوية المنشطة للذهن، ومضادات الأكسدة، والعوامل المغذية للأعصاب لهذا الغرض، مثل سيريبروليسين، الذي يحتوي على ببتيدات عصبية نشطة بيولوجيًا ذات وزن جزيئي صغير. لهذا الدواء تأثير متعدد الأطياف على أعضاء الدماغ، إذ يُثبّت العمليات الأيضية فيه، ويُوفّر تأثيرًا وقائيًا للأعصاب. يُعطى سيريبروليسين وريديًا أو عضليًا، بجرعات مُختارة بشكل فردي. الآثار الجانبية المحتملة: فقدان الشهية، والصداع، والنعاس، وتسرع القلب.
يُمثَّل الجيل الجديد من الأدوية الوقائية العصبية بحاصرات قنوات الكالسيوم، ومضادات مستقبلات NMDA، ومضادات الأكسدة، واللازارويدات، وحاصرات الإنزيمات. ويجري حاليًا دراسة نظائر هذه الأدوية، وخاصةً عوامل النمو المُستخرَجة بطريقة الحمض النووي المُعاد التركيب.
في بعض الحالات، يكون العلاج المضاد للالتهابات غير الهرموني فعالاً.
في حالة اضطرابات الأوعية الدموية، يهدف العلاج إلى تحسين الدورة الدموية في الدماغ، وتحسين العمليات الغذائية، مما يساعد على التخلص من الترسبات. لتحسين الدورة الدموية الدماغية، تُستخدم أدوية سيناريزين، وأكتوفيجين، وسيريبرولايسين، ونوموديبين، بالإضافة إلى أدوية مستخلصة من نبات الجنكة بيلوبا. يُؤخذ سيناريزين قرص واحد ثلاث مرات يوميًا.
في بعض الأحيان يكون من الضروري استخدام الأدوية التي تؤثر على أنظمة الناقلات العصبية:
- محاكيات الكولين (ريفاستيجمين، جالانتامين، دونيبيزيل)؛
- مثبتات وظيفة نظام الغلوتامات (ميمانتيل).
في حالة حدوث ارتباك دوري في الوعي، تُستخدم جرعات صغيرة من هالوبيريدول وريسبيريدون. في حالة الاضطرابات الاكتئابية، تُستخدم مضادات الاكتئاب، وفي حالة الهلوسة، تُستخدم مضادات الذهان.
العلاج الطبيعي
في الفترة الأولية، مع الأمراض الخفيفة والمتوسطة، مع التفاقم التدريجي، يتم استخدام العلاج الطبيعي كجزء من العلاج المعقد، والذي يشمل النظام الغذائي، وتناول بعض الأدوية (على سبيل المثال، مضادات الاكتئاب، والأدوية لتحسين الدورة الدموية الدماغية، وما إلى ذلك).
تساعد الطرق غير الدوائية على:
- إبطاء تقدم المرض وتحسين نوعية الحياة؛
- تصحيح النشاط الحركي؛
- تحسين إمدادات الدم إلى الدماغ.
يُلاحظ التأثير الإيجابي للعوامل الفيزيائية من خلال تحسين الدورة الدموية في الدماغ، وزيادة إنتاج الدوبامين، وزيادة حساسية مستقبلاته له، وتنشيط عمليات إطلاقه من الحيز قبل المشبكي، وزيادة النشاط الوظيفي. في بعض الحالات، يُتيح استخدام العلاج الطبيعي تقليل جرعة الأدوية، وهو أمر مهم في الحالات المرضية المتقدمة المعرضة للمضاعفات.
يُوصف الرحلان الكهربائي للمواد الطبية عادةً لتنشيط الدورة الدموية الدماغية وتخفيف الأعراض المرضية. وتُستخدم الأدوية التالية بكثرة: حمض النيكوتينيك بتركيز 0.5-1%، وحمض الأسكوربيك بتركيز 2-5%، ويوديد الصوديوم والبوتاسيوم بتركيز 2-5%، ودروتافيرين بتركيز 1-2%، وغيرها. ويُجرى الرحلان الكهربائي باستخدام طريقة الطوق أو طريقة الحجاج القذالي. ويُعدّ الرحلان الكهربائي للهيبارين مناسبًا عند الحاجة إلى خفض تخثر الدم ومستويات الكوليسترول، بالإضافة إلى تأثيره المضاد للتصلب ونقص الأكسجين.
تُستخدم تيارات مُعدّلة جيبيًا للتأثير على الجهاز العصبي الحركي الدماغي الشوكي. بعد إتمام دورة العلاج بالنبضات المُضخّمة، تُوصف حمامات كبريتيد الهيدروجين أو الرادون، حسب الحاجة.
يُحسّن النوم الكهربائي، على شكل نبضات تيار مستمر على تكوينات الدماغ تحت القشرية الجذعية، الدورة الدموية، ويُحسّن الحالة الوظيفية لهذه البُنى، ويُعزز تخليق بيتا إندورفين. تُجرى الإجراءات باستخدام طريقة المدار القذالي، على مدار ١٢ جلسة. يُنصح بالنوم الكهربائي بشكل خاص للمرضى الذين يعانون من أعراض اكتئاب.
يُستخدم علاج دارسونفال لتحفيز مراكز الدماغ وتحسين التغذية. يُطبّق العلاج موضعيًا، يوميًا أو كل يومين، حتى ١٥ جلسة لكل دورة.
للمجال الكهربائي بالموجات فوق العالية (UHF) تأثير حراري، ويزيد من إفراز الدوبامين والنورإبينفرين. يُمارس غالبًا مزيج من العلاج بالموجات فوق العالية (UHF) والنوم الكهربائي. يحظى هذا النهج بإقبال كبير من المرضى، وله تأثير إيجابي على الحالة النفسية والعاطفية، ويُخفف من حدة أعراض القلق والاكتئاب والاضطرابات الإدراكية.
ولتحقيق تأثير توسع الأوعية الدموية ومضاد للالتهابات ومزيل للحساسية، يتم استخدام موجات كهرومغناطيسية عالية التردد، وإذا كان التأثير الدوباميميكي ضروريًا، يتم وصف العلاج بالضوء.
العلاج بالأعشاب
يقدم محبو العلاجات البديلة والعلاجات الشعبية وصفاتهم الخاصة للتخلص من الآلام. في بعض الحالات، قد تكون هذه الوصفات فعالة للغاية:
- شاي جذر الزنجبيل؛
- خليط من عصير الجزر والشمندر والرمان؛
- شاي بذور البقدونس.
يُحضّر الشاي بملعقة صغيرة من المادة النباتية لكل 200-250 مل من الماء المغلي، ويُنقع لمدة 6-8 ساعات. كما يُمكن استخدام أوراق النعناع والليمون وزهر الزيزفون بنجاح في العلاج.
النوبات المستمرة، في حد ذاتها، لا تُشكل أي خطر على حياة الإنسان. ومع ذلك، قد تُشير في بعض الحالات إلى تطور أمراض خطيرة. لذلك، لا يُمكن الاعتماد كليًا على الطب التقليدي: من المهم استشارة الطبيب في الوقت المناسب، والخضوع لعلاج مُؤهل عند الحاجة.
إذا ظهرت أعراض الإدمان لدى شخص يُسيء استخدام الكحول، يُمكنك استخدام منقوع لحاء روان للتخلص من هذه الأعراض. خذ 50 غرامًا من الجذمور، وانقعه في 200 مل من الماء المغلي، ثم انقعه في ترمس لمدة خمس إلى ست ساعات. ثم صفِّ المنقوع، وتناول 80 مل حتى خمس مرات يوميًا.
لعلاج اضطرابات الخرف الشيخوخي، يُحضّر مستحضر صبغة الراسن. يُخلط 500 مل من الفودكا مع 50 غرامًا من المادة الخام، ويُترك في زجاجة لمدة شهر مع التقليب الدوري. بعد شهر، يُصفّى المستحضر ويُؤخذ ملعقة كبيرة بين الوجبات عدة مرات يوميًا.
لعلاج القلق، يُنصح بتحضير دواء من الزمانيها. اخلط 10 غرامات من جذمور النبات مع 100 غرام من الفودكا، واتركه لمدة أسبوعين، ثم صفِّه. تناول 20 قطرة من الصبغة ثلاث مرات يوميًا.
إذا كان سبب النعاس قلة نوم مزمنة أو خرفًا، يُعالج بالنعناع. انقع ملعقة صغيرة من النعناع في 200 مل من الماء المغلي، واتركه لمدة 15-20 دقيقة. اشرب كوبًا واحدًا ثلاث مرات يوميًا، بدلًا من الشاي.
في حالة الإثارة المفرطة، استخدم مغلي جذر حشيشة الهر والشمر (خليط بنسب متساوية). خذ ملعقتين كبيرتين من المواد الخام، واسكب نصف لتر من الماء المغلي، واتركه يغلي على نار هادئة لمدة 10 دقائق. غطِّ الوعاء واتركه لمدة ساعة، ثم صفِّه. تناوله مرتين يوميًا - صباحًا ومساءً - بجرعة 150-200 مل.
العلاج الجراحي
لا يُعدّ العلاج الجراحي أساسيًا في حالات الاضطراب المُستمر. ومع ذلك، قد يُوصف العلاج الجراحي لبعض الأمراض التي قد تُسبب اضطرابات مُستمرة. على سبيل المثال، قد يلزم الاستعانة بجراح:
- في التشوهات الوريدية الشريانية للأوعية الدماغية؛
- في تمدد الأوعية الدموية الكيسي في الشرايين الدماغية؛
- في عمليات الورم في الدماغ، الورم السحائي، الأورام النقيلية؛
- في بعض الاضطرابات الإقفارية في الدورة الدموية الدماغية (عمليات الأوعية الدموية)؛
- في حالة وجود أورام دموية داخل المخ ذات أصل رضحي وغير رضحي، وما إلى ذلك.
الطريقة الأكثر استخدامًا لإجراء العمليات الجراحية هي الطريقة التنظيرية، ويرجع ذلك إلى انخفاض الصدمة وفعالية هذا التدخل.
الوقاية
لا توجد إجراءات وقائية محددة للوقاية من النوبات، نظرًا لتعدد أسباب حدوثها. لذا، فإن توصيات الوقاية غالبًا ما تكون عامة.
يمكن أن تكون التدابير الوقائية أولية وثانوية.
تشمل التدابير الأولية تلك التي تهدف إلى منع ظهور أي أعراض نفسية مرضية وعصبية. ويوصي الخبراء بمنع وقوع المواقف النفسية المؤلمة في الحياة اليومية وفي العمل/المدرسة، وتخصيص وقت واهتمام كافٍ للأطفال.
تهدف التدابير الوقائية الثانوية مباشرةً إلى منع تكرار السمات الملازمة. ولهذا الغرض، يُنصح باستخدام عدة طرق في آنٍ واحد:
- بمساعدة العلاج النفسي وغيره من الإجراءات والجلسات المماثلة، يتم تشكيل استجابة إنسانية مناسبة لجميع أنواع المواقف النفسية المؤلمة والمجهدة؛
- - يتم تحديد ضرورة الالتزام بجميع المواعيد والتوصيات المقدمة من قبل المتخصصين؛
- يصف العلاج المقوي العام، ويضمن الراحة والنوم الكافيين والكاملين؛
- يُستبعد تمامًا استهلاك الكحول والمنشطات والمخدرات؛
- يتم إجراء بعض التغييرات على النظام الغذائي: يتم إثراء النظام الغذائي بالفيتامينات والعناصر الدقيقة، ويتم زيادة نسبة الأطعمة الغنية بالتريبتوفان (مادة أولية للسيروتونين)، ويتم الحد من استهلاك الشوكولاتة الداكنة والقهوة.
ولمنع تكرار هذه الأعراض ينصح المرضى بعدم الاقتصار على نظام غذائي صحي وإضافة المنتجات التالية إلى نظامهم الغذائي:
- الأجبان الصلبة (السويسرية، روكفور، شيدر، بوشيكونسكي)؛
- بيض الدجاج والسمان؛
- فول الصويا؛
- جبنة الفيتا، جبنة الفيتا؛
- الكافيار الأحمر؛
- منتجات الألبان؛
- بذور عباد الشمس؛
- لحم الديك الرومي؛
- السمسم؛
- الكاجو والفستق والبندق والفول السوداني؛
- البقوليات (الفاصوليا، البازلاء، العدس، الحمص)؛
- سمك السلمون الوردي، الحبار، الرنجة، سمك القد، سمك البولوك، سمك الماكريل الحصاني؛
- دقيق الشوفان؛
- الجبن القريش (غير قليل الدسم)؛
- الخضروات والقرنبيط؛
- الفواكه المجففة؛
- الفطر.
من بين الحبوب ومنتجات الحبوب والبقوليات، يجب إعطاء الأفضلية للبازلاء والحنطة السوداء ودقيق الذرة ودقيق الشوفان.
توقعات
يعتمد التشخيص كليًا على السبب الكامن وراء اضطرابات الهوس. أسوأ نتيجة هي اكتساب مسار مزمن للمرض. تجدر الإشارة إلى أن العديد من المرضى الذين شُخِّصت لديهم اضطرابات هوس مرضية قد يحظون بحالة مستقرة طويلة الأمد، وهو أمر شائع بشكل خاص لدى الأشخاص الذين يعانون من أي شكل من أشكال الهواجس. في مثل هذه الحالة، تخف الأعراض السريرية ويكون التكيف الاجتماعي مثاليًا.
تُعالَج حالات الاضطراب الخفيفة في العيادات الخارجية. يُظهِر معظم المرضى تحسنًا خلال السنة الأولى من العلاج. أما الحالات الشديدة من الاضطراب، التي تتضمن هواجس متعددة وحالات رهابية وطقوسًا في بنيتها، فتميل إلى الاستقرار ومقاومة العلاج والانتكاسات المتكررة. يمكن أن تُحفَّز الانتكاسات بنوبات صدمة نفسية متكررة أو جديدة، والإرهاق المفرط (سواءً الجسدي أو العقلي أو العاطفي)، والهزال العام، وقلة الراحة (بما في ذلك الراحة الليلية).
إن المثابرة في مرحلة الطفولة لها تشخيص أكثر تفاؤلاً من تلك الموجودة في المرضى المسنين وكبار السن.

